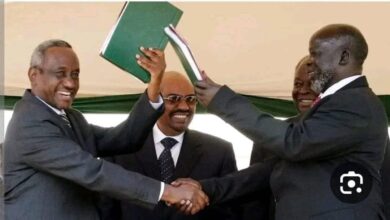خارطة طريق السلام… أم خارطة أزمة الدولة؟
متابعات -السودان الآن– في لحظات الانهيار الكبرى لا تسقط الدول بالسلاح وحده، بل تسقط أولًا في وعي مواطنيها، حين تفقد معناها الأخلاقي وقدرتها على تمثيل الجميع. وهذا هو جوهر ما يعيشه السودان اليوم.
المبادرات السياسية المطروحة، سواء تلك التي يقدمها رئيس الوزراء أو ما يُعرف بخارطة الطريق التي يتبناها الجيش، تنطلق من افتراض مضلل مفاده أن الدولة ما تزال قائمة، وأن ما تحتاجه فقط هو إدارة أفضل وترتيبات سياسية جديدة.
لكن الحقيقة أكثر قسوة: السودان لا يواجه أزمة سلطة فحسب، بل أزمة سؤال أعمق وأخطر.
ما هي الدولة؟
ومن يملكها؟
ولمن تُبنى؟
ومن يحق له أن يشعر أن هذه الأرض وطن آمن، لا ساحة تهديد لوجوده؟
من منظور الفلسفة السياسية، لم يكن العقد الاجتماعي في السودان يومًا عقدًا عادلًا أو مكتملًا بين جميع مكوناته. حين تحدث هوبز ولوك وروسو عن العقد الاجتماعي، افترضوا دولة يتنازل فيها المواطنون عن جزء من قوتهم مقابل ضمان الأمن والحقوق بالتساوي.
لكن الدولة السودانية، في بنيتها التاريخية، لم تنجح في إنتاج هذا النموذج. نشأت دولة يشعر بعض مكوناتها أنهم مالكوها، بينما يعيش آخرون داخلها كأنهم ضيوف، أو كأن وجودهم مشروط بالقوة لا بالقانون.
لهذا، حين ضعفت قبضة السلطة، لم يجد الناس الدولة في وعيهم، بل عاد كل طرف إلى قبيلته وهويته وذاكرته وسلاحه.
في هذا السياق، يبدو خطاب الجيش اليوم – وهو يرفع شعار الشرعية ويتصرف باعتباره الممثل الوحيد للدولة – صحيحًا من حيث الشكل، لكنه غير واقعي من حيث الجوهر. فالصراع لم يعد مجرد تنازع سلطة بين مؤسسة رسمية وقوة متمردة، بل تحول إلى صراع مجتمعات وهويات وذاكرات ومخاوف وجودية.
هناك مجتمعات تدعم الجيش لا بوصفه مؤسسة وطنية فحسب، بل لأنه آخر جدار يحمي امتيازاتها التاريخية وموقعها في بنية الدولة. وفي المقابل، ترى مجتمعات أخرى في قوات الدعم السريع أول أداة امتلكتها في تاريخها لحماية وجودها وفرض حضورها بعد عقود طويلة من التهميش، لا كنخب، بل كمجتمعات كاملة.
وهذا ليس استثناءً سودانيًا. التاريخ مليء بأمثلة لدول فشلت في إدارة التنوع:
لبنان خلال الحرب الأهلية، البوسنة والهرسك، العراق بعد 2003، رواندا، بل وحتى دول إفريقية قريبة مثل ليبيريا وسيراليون ومالي وإفريقيا الوسطى. في كل هذه الحالات، سقطت الدولة من الوعي قبل أن تسقط من الواقع.
اليوم، الحقيقة الأعمق في السودان هي أن الجميع خائف.
القبائل العربية في دارفور وكردفان خائفة من الإقصاء والتجريد من أدوات القوة.
الزغاوة والفور وغيرهم خائفون من عودة ماضٍ كانوا فيه أقل حضورًا وأضعف صوتًا.
مجموعات الوسط والشمال تخشى فقدان مركز السيطرة التاريخي.
والجيش نفسه يخشى انهيار صورته باعتباره الحارس الأخير للدولة – وبالضرورة لمجتمعات بعينها.
من هنا تأتي خطورة المبادرات الحالية حين تعيد إنتاج الأزمة بدل حلها، خصوصًا عندما يُطلب من مكونات بعينها تسليم سلاحها، بينما يُسمح لغيرها بالاحتفاظ به.
هذا ليس إجراءً أمنيًا، بل رسالة سياسية تقول: هناك من يحق له أن يظل قويًا بحكم تاريخه ومكانته، وهناك من عليه إعلان الهزيمة ثم انتظار ما يُمنح له من حقوق.
هذه اللغة لا تبني دولة، بل تحفر قبرها بعمق أكبر.
الحل في السودان لن يولد من تعيين حكومة انتقالية، ولا من تسويات فوقية بين نخب المدن. الحل يبدأ بالاعتراف أننا أمام أزمة مجتمع قبل أن تكون أزمة سلطة، وأمام عقد اجتماعي منتهي الصلاحية يحتاج إلى إعادة تأسيس عادلة وشجاعة.
دولة لا تقوم على الغلبة التاريخية، ولا على ذاكرة الانتقام، ولا على شعور بعض المكونات بأنها المالكة الوحيدة للوطن، بينما الآخرون مجرد ملحقين.
بل دولة يشعر الجميع فيها أن أمنهم مضمون بوجودها، لا بسلاحهم.
السودان اليوم يقف أمام مفترق تاريخي حاد:
إما أن يولد من هذا الألم عقد اجتماعي جديد يعيد للدولة معناها الأخلاقي الجامع،
أو يدخل البلاد في تاريخ طويل من الحروب المتقطعة، حيث ينتظر كل طرف دوره في الخسارة.
والسؤال لم يعد: من سينتصر؟
بل: أي دولة نريد أن تولد من رحم هذا الجرح؟